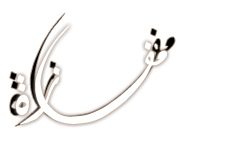-١-
كيف اختلفت “النخبة المثقفة” السعودية حول اليوم الوطني؟
الجواب بسيط: كان الخلاف حول سؤال: هل الوطن هو الحكومة أم أنه أكبر بكثير من الحكومة؟ وتحول الخلاف من كونه خلافا بين وجهات نظر، إلى معيارا يتم بواسطته توزيع الأحكام على الآراء، فمن يستغل اليوم الوطني من أجل صب المدائح على الحكومة أصبح مرتزقا، بوقا، أو وطنيا حقا؛ أما ذاك الذي يؤكد على أن الوطن أكبر من الحكومة، ويدعو لأن يكون هذا اليوم إعادة تأكيد على الإصلاحات المطلوبة من الحكومة، اعتبر نفسه أنه هو الوطني حقا، والإصلاحي، وقد يُنظر إليه بأنه محرض ومحاولا لشقّ الصف.
ما يهم هنا ليس السهولة التي تتحول فيها الخلافات الفكرية السعودية إلى مناسبات تبادل شتائم وتخوين وتكفير؛ ما هو شديد الأهمية في هذا الخلاف حول اليوم الوطني، أن الفريقين – شاءو أم أبو- منشغلين بالحكومة أكثر من انشغالهم في “ما يعنيه هذا اليوم”. فمهما جادل ذاك الذي يؤكد على أن الوطن أكبر من الحكومة، فهو إنما يفعل ليسمح لنفسه انتقاد الحكومة دون أن يحسب نقده هذا نقدا للوطن، الأمر الذي يستتبع الخيانة.
وإذا كان انشغال “النخبة المثقفة” في اليوم الوطني يتكشف بسهولة عن انشغال بالحكومة- أي بالحاضر- فهذا لا يعني أكثر من تفريغ “اليوم الوطني” من محتواه. يتأتى ذلك عبر تحويله إلى وسيلة تخدم غايات محددة، والتي مهما كان نبلها فهو أبدا لا يبرر ما يتطلبه هذا اليوم تحديدا من الكفّ عن الانشغال بالحاضر من أجل التوجه إلى الماضي، إلى تلك اللحظة التاريخية -التي لا يعني الاحتفاء بذكراها سوى محاولة تخليدها، محاولة حمايتها من أن تنزلق إلى هاوية النسيان- أي لحظة تأسيس المملكة العربية السعودية.
-٢-
سُئل كليمنصو “ماذا تتوقع أن تقوله الأجيال القادمة عن الحرب العالمية؟” فكان جوابه: “لا أعلم، لكن ما أعلمه يقينا أنهم لن يقولوا أن بلجيكا هي من غزت ألمانيا”. مثل هذا النوع من “الوقائع” الجليّة لا يمكن تزييفه أو تحريفه، فمهما سيقال عن حرب الخليج الثانية، فلن يقال أبدا أن الكويت هي من غزت العراق. لكن للأسف أن واقعة شديدة الأهمية لنا كسعوديين مثل واقعة تأسيس المملكة تم اختطافها من قبل أسطورة “السيف الأملح”.
غريب جدا رواج مثل هذه الأسطورة التي مفادها أن تأسيس المملكة تمّ بالقوّة، أي أن جزءا من المجتمع- فردا كان، أو أسرة، أو إقليم- قام بإخضاع البقية لحكمه بـ”السيف”؛ هو غريب لأنه يماثل في إيغاله في الخطأ قولنا أن الكويت هي من غزت العراق. وهذه الأسطورة سائدة لدرجة أن الكثير يصدقها، من مستفيدين يشتقون منها شرعية مزيفة، أو متضررين يسعون لتجاوز هذه “الخطيئة الأصلية” عبر المطالبة بـ”تأسيس جديد” – أو عقد جديد- يمكن اشتقاق شرعية جديدة منه. يوجد هناك من يبرر جبنه عن مواجهة المظالم بأن هذا “حكمهم الذي أخذوه بالسيف”، وكذلك يوجد آخر – وبينما يواجه المظالم- يفسر حدوثها بأنه أثر طبيعي لحكم نيل بالقوّة والإخضاع.
مشكلة هذه الأسطورة أنها ليست فقط تزيف الماضي، بل أيضا تلعب دورا أساسيا في تأسيس نوع من الامبريالية المحلية؛ إذ أن المؤدى النهائي لها أن كل العظمة التي كانتها لحظة تأسيس المملكة باعتبارها حالة توحيد من الطراز النادر، ستنحل فجأة إلى محض احتلال نجدي لباقي الأقاليم، لم يكن وما كان له أن يكون لولا عامل السيف. باختصار شديد، ما يقوله من يعتقد بهذه الأسطورة أن ما حدث في الربع الأول من القرن العشرين في الجزيرة العربية لم يكن “توحيدا” بل كان “احتلالا”. ونظرا لانتشار مثل هذه الأسطورة في قطاعات مختلفة، بين النجديين الذين فعلا صدقوا الكذبة وبدأو يفكرون بمنطق المحتل للدرجة التي جعلت أحدهم- دون أي وعي منه- يقسم الوطن إلى إنسان وسطى وشمال وجنوب، موزعا ولاءات الجميع لغير ما يرى أنه “الوطن”- الذي لن يعني بالنسبة له سوى الوسطى. وكذلك بين غيرهم الذين بدأت تنتشر بينهم “ذهنية الضحيّة” التي بعد وعيها بمأساتها، بدأت تطالب بـ”حقوقها”، التي لن تكون إلا حصة “عادلة” من كعكة الحكومة، تجدهم يتسائلون مثل هذه الأسئلة: لماذا عدد وزراء المنطقة الفلانية أكثر من عدد وزراء تلك المنطقة، ولماذا توجد مشاريع هناك أكثر من هنا. أنا طبعا لا أنفي التحيز الواضح في أجهزة الدولة، لكن مقابلته بمطالبة من نوع “المحاصصة”- التي لا تذكر بشيء أكثر من نظام المحاصصة اللبنانية- لا يعني أكثر من اعتراف أن “نحن” لم تعد أبدا تعني “نحن السعوديين”، بقدر ما تعني “نحن” المحرومين- ضحايا الاحتلال- و”أنتم” المترفين- المحتلين.
يمكن الإشارة إلى ظواهر كثيرة لا يجمعها إلا انطلاقها من هذه الاسطورة، لعل أكثرها إفصاحا – وسخرية أيضا- أن الأحتفال باليوم الوطني، الذي يفترض فيه لحظة استعادة تمجيدية لتلك اللحظة العظيمة، ينحل إلى “محاولة نسيانها” والتطهر من عارها وذلك عبر تحويلها إلى محض وسيلة، يتم استخدامها في أغراض مختلفة: تبدأ من “ترقيم الفتيات” ولا تنتهي بإصلاح الحكومة. إنه لخطر شديد أن تتحاشى أمة ذاكرتها، أن لا تستعيده بنوع من الفخر والاعتزاز.
-٣-
إن الحديث عن توحيد المملكة يصبح بلا معنى دون استلهام الوضع العام للجزيرة العربية مطلع القرن العشرين، حيث كانت الجزيرة مقسمة إلى حواضر- على شكل قرى ومدن صغيرة- وبادية – قبائل تمتد في فضاء جغرافي لا يتوفر على حدود بالمعنى السياسي الحديث. كانت الحواضر وحدات شبه سياسية إما خاضعة لحاميات تركية، أو خاضعة لإمارة محلية تابعة إما لحماية بريطانية (إمارة الكويت، ومملكة الهواشم في الحجاز مثلا) أو لسلطة عثمانية (إمارة آل رشيد). وكان الحدث الجديد الذي تم تدشينه بدخول الأربعين مقاتلا إلى الرياض عام ١٩٠٢، هو تأسيس كيان يضم هذه الوحدات المتنوعة بحيث لا تكون خاضعة لأي قوة خارجية: لا حماية بريطانية ولا سلطة عثمانية. وتم تأسيس هذا الكيان- لا بالسيف بل بالتوافق والتعاون والتعاضد بين الغالبية العظمى من الحواضر والقبائل المنتشرة في جزيرة العرب- ليكون فضاءً عاما يوفر الأمن والاستقرار والعدل للجميع، مع الحرص على احترام استقلالية كل حاضرة وقبيلة في إدارة شؤونها. وهذا الأمر ليس أمنيات يتم بنائها في الماضي بأثر رجعي، بل وقائع تكشف عن نفسها بكل وضوح، فمهما تكن أمانينا حول أحداث حرب الخليج، فلن نستطيع أبدا أن نجعل الكويت هي من غزت العراق.
بحسب التقسيم الإداري الحالي للمملكة، يمكن القول أن جميع مناطق المملكة دخلت طواعية وسلما في الكيان السياسي الجديد الذي أسسه الملك عبدالعزيز، ما عدا حائل وعسير والحجاز، في حين أن كامل نجد، والشمال والمخلاف السليماني ونجران والأحساء والقطيف، كله انضم سلميا، بل إن حالتي القطيف ونجران تمثّل ذروة ما نريد إثباته هنا. فالقطيف- ذات الأغلبية الشيعية- عندما كان بيدها أن تختار بين أن تتحول إلى محمية بريطانية – مثل الكويت والبحرين وقطر وغيرها- أو تنظم لهذا الكيان الجديد الذي للتو طرد العثمانيين من جارتها الأحساء، اختارت الأخيرة. أما نجران- ذات الأغلبية الإسماعيلية- التي تعرضت لغزو من الجيش اليمني، اختارت التعاهد مع الدولة الجديدة من أجل طرد الجيش اليمني.
وحتى المناطق التي كانت إمارات وممالك سابقة، لم يتم “احتلالها” أو “اخضاعها بالقوّة”؛ فحائل مثلا كانت الاتفاقية بين أهلها والملك عبدالعزيز “أن لكم ما لنا وعليكم ما علينا”، بشرط أن يتم التخلص من آل رشيد، وكذلك الأمر فيما يتعلق بمكة وجدة والمدينة حيث كلها انضمت للدولة الحديثة بمعاهدات واتفاقيات لا تشبه أبدا اتفاقيات الاستسلام التي ترافق عادة الاحتلال والاخضاع بالقوة؛ ولا يمكن تسميتها احتلالا إلا إذا كان دخول قوات الثوار الليبيين إلى طرابلس يعتبر “احتلالا”، أو أن إخضاع ابراهام لينكولن للولايات الجنوبية في الحرب الأهلية الأمريكية يعتبر احتلالا.
نعم حدثت معارك وحروب، لكن محض حدوثها لا يبيح أبدا أن يستنتج المرء أن ثم احتلالا قد وقع.
إن نفي أسطورة “السيف الأملح”، يعني تهاوي قصتين كبريين مؤسستين عليها. القصة الأولى التي ترى أن التأسيس هي – كما يذكر عادة في بعض الكتب- “قصة المعارك والحروب التي خاضها الملك عبدالعزيز”، والقصة الثانية التي لا ترى في كل الحكاية إلا صناعة بريطانية. هاتان القصتان لا تستقيمان ولا تكتسبان أي وجاهة بدون أسطورة “السيف الأملح”. إذ أن كون توحيد المملكة لم يتم بالقوّة والاحتلال، يعني بالنسبة للقصة الأولى أن الجميع شارك فيه وبالتالي ينهار وهم أن التاريخ يمكن أن يصنع من قبل بطل واحد، ويعني بالنسبة للثانية أنه طالما أن المخطط كان بريطانيا، فإن النتيجة ستكون بالغة السخف، إذ فحواها أن الجميع “عملاء”.
وكون أن الجميع- تجار، علماء، فرسان، مثقفين، رجالات دولة…إلخ- شارك في لحظة التأسيس لهو الأمر الحاسم والجوهري الذي تم نسيانه من قبل الجميع، وهو ما يجب تذكره هذه الأيام.
-٤-
لماذا تم نسيان أن لحظة التأسيس كانت نتيجة جهود الجميع؟
عادة، لا يتم نسيان مثل هذا النوع من اللحظات التاريخية، إلا عندما يأتي بعده حدث تاريخي آخر، ينفي الحاجة للعودة لتلك اللحظة لاستلهامها والعودة إلى روحها. وهذا الحدث التاريخي الآخر لن يكون شيئا سوى “اكتشاف النفط”.
إن اكتشاف النفط، وما استتبعه من أموال هائلة صبت في ميزانية الدولة التي أعادت توزيعه على المجتمع على شكل مشاريع ومؤسسات وفرص وظيفية، قام بعملية قلب كبرى للعلاقة بين الدولة والمجتمع. فالدولة التي انبثقت من جهود الجميع في تأسيسها، أصبحت – بسبب النفط- غير محتاجة لهذا الجميع، الذي أصبح بدوره عالة عليها. فالنفط الذي استطاع أن يصعد بالمجتمع إلى معايير حياة عالية في أوائل الثمانينات- فيما يسمى بالطفرة حيث وصل معدل دخل الفرد الى حوالي الـ٢٠ألف دولار؛ جعل الجميع سعداء، ويستطيعون بسهولة نسيان الحدث الرئيسي الذي قام بجمعهم سوية والذي جعل بئر نفط في المنطقة الشرقية يستفيد منه القاطنين في جازان أو القريات.
لكن هذا النفط – الذي وصلت اسعاره إلى مستويات منخفضة في التسعينات الميلادية- سرعان ما جعل الدولة التي ينهشها الفساد- حتى بعد الارتفاع الساحق للأسعار في السنوات الماضية- عاجزة عن توفير نفس المستوى من المعايير لمجتمع يمر بطفرة ديموغرافية كبرى. وهنا تحديدا، عندما ذهبت سكرة النفط، نشطت عمليات “تذكّر” متنوعة تبحث في الماضي ما تبرر فيه واقعها، فلم تفعل أكثر من اكتشاف وتأسيس أسطورة “السيف الأملح”، الأسطورة التي أنّا قلبت وجهك في التاريخ فلن تجد ما يبررها.
إن اليوم الوطني إذن، هو الاحتفال بهذا الحدث التاريخي الضخم، الذي – على الرغم من كل امتعاضاتنا ورفضنا للواقع الحالي- يمكن أن تلعب “ذكراه” دورا ملهما يجعل ابناء المناطق والقبائل المختلفة يجدون ما يجمعهم سوية، ما يحملهم على أن يكون سعيهم لإصلاح بلدهم ينطلق من الحقيقة البسيطة التي وإن أمكن نسيانها فلا يمكن طمسها:
“أنهم جميعا أحفاد أولئك الذين شاركوا في تأسيس هذا البلد، وأنهم أيضا أجداد من يريدون لهم العيش فيه بكرامة وحرية ورفاهية”